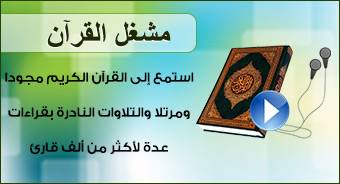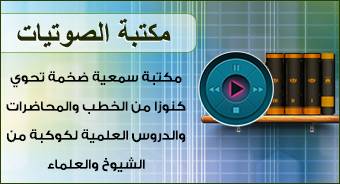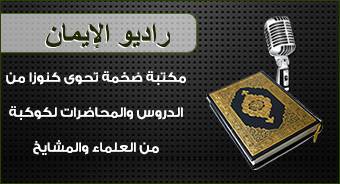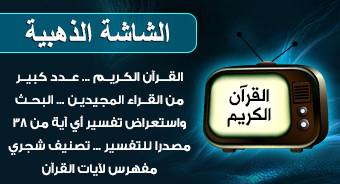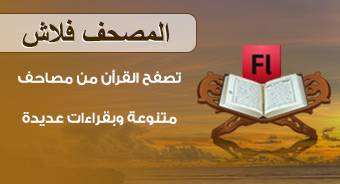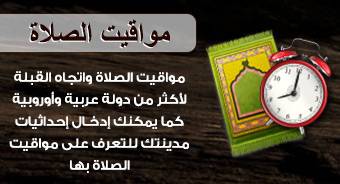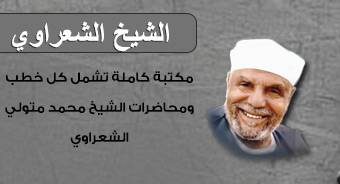|
الصفحة الرئيسية
>
شجرة التصنيفات
كتاب: الحاوي في تفسير القرآن الكريم
قوله: {يغشى} قراءة حمزة والكسائي بالتاء من فوق، والباقون بالباء؛ ردًّا إلى النُّعَاسِ، وخرَّجوا قراءة حمزة والكسائي على أنها صفة لـ {امَنَةً}؛ مراعاة لها، ولابد من تفصيل، وهو إن أعربوا {نُعَاسًا} بدلًا، أو عَطْفَ بيانٍ، أشكل قولهم من وَجْهَيْن:الأول: أن النُّحاة نَصُّوا على أنه إذا اجتمع الصفةُ والبدلُ أو عَطْفُ البيانِ، قدِّمت الصفة، وأخر غيرها، وهنا قد قدَّموا البدلَ، أو عطف البيانِ عليها.الثاني: أن المعروفَ في لغة العرب أن يُحَدَّث عن البدل، لا عن المبدَل منه، تقول: هِنْد حُسْنُها فاتِنٌ، ولا يجوز فاتنة- إلا قليلًا- فَجَعْلُهم {نُعَاسًا} بدلًا من {أمَنَةً} يضعف لهذا.فإن قيل: قد جاء مراعاة المبدَل منه في قول الشاعر: [الكامل]
فقال: مُعَيَّنٌ مراعاة للهاء في كأنه ولم يُرَاعِ البدل- حاجبيه- ومثله قول الآخر: [الكامل] فقال: تركت؛ مراعاة للسيوف، ولو راعَى البدل لقال: تركا.فالجوابُ: أنَّ هذا- وإن كان قد قَالَ به بعضُ النحويينَ؛ مستندًا إلى هذين البيتين- مُؤوَّلٌ بأن معين خبر لِحاجبيه لجريانهما مَجْرَى الشيء الواحدِ في كلام الْعَرَبِ، وأنَّ نصب غُدُوَّهَا وَرَوَاحَهَا على الظرف، لا على البدل. وقد تقدم شيء من هذا عند قوله: {عَلَى الملكين بِبَابِلَ هَارُوتَ وَمَارُوتَ} [البقرة: 102].وإن أعربوا {نُعَاسًا} مفعولًا به و{أمَنَةً} حالٌ يلزم الفصل- أيضا- وفي جوازه نظر، والأحسنُ- حينئذٍ- أن تكون هذه جملة استئنافية جوابًا لسؤال مقدَّر، كأنه قيل: ما حكم هذه الأمَنَة؟ فأخبر بقوله: تغشى.ومن قرأ بالياء أعاد الضمير على {نُعَاسًا} وتكون الجملة صفة له، و{مِنْكُمْ} متعلق بمحذوف، صفة لِـ {طَائِفَةً}.قوله: {وَطَائِفَةٌ قَدْ أَهَمَّتْهُمْ أَنْفُسُهُمْ} في هذه الواو ثلاثة أوجهٍ:الأول: أنها واو الحالِ، وما بعدها في محل نَصْبٍ على الحال، والعامل فيها {يَغْشَى}.الثاني: أنها واو الاستئناف، وهي التي عبر عناه مَكيٌّ بواو الابتداء.الثالث: أنها بمعنى {إذْ} ذكره مَكي، وأبو البقاءِ، وهو ضعيفٌ.و{طائفة} مبتدأ، والخبر {قَدْ أَهَمَّتْهُمْ أَنْفُسُهُمْ} وجاز الابتداء بالنكرة لأحدِ شيئين: إما للاعتمادِ على واو الحالِ، وقد عده بعضهم مسوغًا- وإن كان الأكثرُ لم يذكره-.وأنشدوا: [الطويل] وإما لأن الموضعَ تفصيلٌ؛ فإن المعنى: يغشى طائفةً، وطائفة لم يغشهم.فهو كقوله: ولو قُرِئ بنصب {طَائِفَة}- على أن تكون المسألةُ من باب الاشتغالِ- لم يكن ممتنعًا إلا من جهة النقلِ؛ فإنه لم يُحْفظ قراءة، وفي خبر هذا المبتدأ أربعة أوجهٍ:أحدها: أنه {أَهَمَّتْهُمْ أَنْفُسُهُمْ} كما تقدم.الثاني: أنه {يَظُنُّونَ} والجملة قبله صفة لِـ {طَائِفَة}.الثالث: أنه محذوفٌ، أي: ومنكم طائفة وهذا يُقَوِّي أنَّ معناه التفصيل، والجملتان صفة لِـ {طَائِفَةٌ} أو يكون {يَظُنُّونَ} حالًا من مفعول {أهَمَّتْهُمْ} أو من {طَائِفَةٌ} لتخصُّصه بالوَصْف، أو خبرًا بعد خبر إن قلنا: {قَدْ أَهَمَّتْهُمْ} خر أول. وفيه من الخلاف ما تقدم.الرابع: أن الخبر {يَقُولُونَ} والجملتان قبله على ما تقدّم من كونهما صفتين، أو خبرين، أو إحداهما خبر، والأخْرَى حالٌ.ويجوز أن يكون {يَقُولُونَ} صفة أو حالًا- أيضا- إن قلنا: إن الخبرَ هو الجملة التي قبله، أو قلنا: إن الخبر مُضْمَرٌ.قوله: {يَظُنُّونَ} له مفعولان، فقال أبو البقاءِ: {غَيْرَ الحق} المفعولُ الأولُ، أي أمرًا غير الحق، و{باللهِ} هو المفعول الثاني.وقال الزمخشريُّ: {غَيْرَ الحق} في حكم المصدر، ومعناه: يظنون باللهِ غير الظن الحق الذي يجب أي يُظَنَّ به. و{ظَنَّ الجاهلية} بدل منه.ويجوز أن يكون المعنى: يظنون بالله ظن الجاهلية و{غَيْرَ الحق} تأكيدًا لِـ {يَظُنُّونَ} كقولك: هذا القول غير ما يقول.فعلى ما قال لا يتعدى ظن إلى مفعولين، بل تكون الباء ظرفية، كقولك: ظننت بزيد، أي: جعلته مكان ظني، وعلى هذا المعنى حمل النحويون قولَ الشاعر: [الطويل] أي قلتُ لهم: اجعلوا ظنكم في الفي مُدَجَّجٍ.ويحصل في نصب {غَيْرَ الحق} وجهان:أحدهما: أنه مفعول أول لِـ {يَظُنُّونَ}.والثاني: أنه مصدرٌ مؤكِّدٌ للجملة التي قبله بالمعنيين اللذين ذكرهما الزمخشريُّ.وفي نصب {ظَنَّ الجاهلية} وجهان- أيضا-: البدل من {غَيْرَ الحق} أو أنه مصدر مؤكِّد لِـ {يَظُنُّونَ}.و{بالله} إما متعلِّق بمحذوف على جَعله مفعولًا ثانيًا، وإما بفعل الظنِّ- على ما تقدم- وإضافة الظنِّ إلى الجاهلية، قال الزمخشريُّ: كقولك: حاتم الجود، ورجل صدقٍ، يريد: الظنَّ المختص بالملة الجاهلية، ويجوز أن يراد ظن أهل الجاهلية.وقال غيره: المعنى: المدة الجاهلية، أي: القديمة قبل الإسلام، نحو: {حَمِيَّةَ الجاهلية} [الفتح: 26].قوله: {يَقُولُونَ هَل لَّنَا مِنَ الأمر مِن شَيْءٍ} {من}- في {مِن شَيْءٍ}- زائدة في المبتدأ، وفي الخبر وجهانِ:أحدهما- وهو الأصحُّ-: أنه {لَنَا} فيكون {مِنَ الأمر} في محل نصبٍ على الحالِ من {شَيءٍ} لأنه نعتُ نكرة، قدم عليها، فنصب حالًا، وتعلق بمحذوفٍ.الثاني:- أجازه أبو البقاء- أن يكون {مِنَ الأمر} هو الخبر، و{لنا} تبيين، وبه تتم الفائدةُ كقوله: {وَلَمْ يَكُنْ لَّهُ كُفُوًا أَحَدٌ} [الإخلاص: 4].وهذا ليس بشيء؛ لأنه إذا جعله للتبيين فحينئذٍ يتعلق بمحذوفٍ، وإذا كان كذلك فيصير {لَنَا} من جملة أخرى، فتبقى الجملةُ من المبتدأ والخبر غير مستقلةٍ بالفائدةِ، وليس نظيرًا لقوله: {وَلَمْ يَكُنْ لَّهُ كُفُوًا أَحَدٌ} فإن {لَهُ} فيها متعلق بنفس {كُفُوًا} لا بمحذوفٍ، وهو نظيرُ قولكَ: لم يكن أحدٌ قاتلًا لبكرٍ. فلبكر متعلق بنفس الخبر. وهل هنا الاستفهام عن حقيقته، أم لا؟ فيه وجهانِ:أظهرهما: نَعَمْ، ويعنون بالأمر: النصر والغلبة.والثاني: أنه بمعنى النفي، كأنهم قالوا: ليس لنا من الأمر- أي النصر- شيء، وإليه ذَهَبَ قتادةُ وابنُ جُرَيْجٍ.ولكن يضعف هذا بقوله: {قُلْ إِنَّ الأمر كُلَّهُ للَّهِ} فإن من نَفَى عن نفسه شيئًا لا يجاب بأنه ثبت لغيره؛ لأنه يُقِرُّ بذلك، اللهم إلاَّ أن يقدر جملة أخرى ثبوتية مع هذه الجملة، فكأنَّهم قالوا: ليس لنا من الأمر شيءٌ، بَلْ لمن أكرهنا على الخروج وحَمَلَنا عليه، فحينئذ يحْسُن الجوابُ بقوله: {قُلْ إِنَّ الأمر كُلَّهُ للَّهِ} لقولهم هذا، وهذه الجملةُ الجوابيةُ اعتراض بين الجُمَل التي جاءت بعد قوله: {وطائفة} فإن قوله: {يُخْفُونَ في أَنْفُسِهِم} وكذا {يَقُولُونَ}- الثانية- إما خبر عن {طَائِفَةٌ} أو حال مما قبلها.وقوله: {قُلْ إِنَّ الأمر كُلَّهُ للَّهِ} قرأ أبو عمرو {كُلُّهُ}- رفعًا- وفيه وجهان:الأول:- وهو الأظهر- أنه رفع بالابتداء، و{لله} خبره والجملة خبر إنَّ نحو: إن مال زيد كله عنده.الثاني: أنه توكيد على المحل، فإن اسمها- في الأصل- مرفوعٌ بالابتداء، وهذا مذهبُ الزَّجَّاجِ والجَرْمي، يُجْرُون التوابعَ كلَّها مُجْرَى عطف النسق، فيكون {للهِ} خبرًا لِـ {إنَّ} أيضا.وقرأ الباقون بالنصب، فيكون تأكيدًا لاسم إنَّ وحَكَى مكي عن الأخفش أنه بدل منه- وليس بواضح- و{للهِ} خبر إنَّ.وقيل على النعت؛ لأنَّ لفظة كُلّ للتأكيد، فكانت كلفظة أجمع.قوله: {يُخْفُونَ} إما خبر لِـ {طَائِفَةً} وإما حال مما قبله- كما تقدم- وقوله: {يَقُولُونَ} يحتمل هذينِ الوجهينِ، ويحتمل أن يكون تفسيرًا لقوله: {يُخْفُونَ} فلا محلَّ له حينئذٍ.قوله: {لَوْ كَانَ لَنَا مِنَ الأمر شَيْءٌ} كقوله: {هَل لَّنَا مِنَ الأمر مِن شَيْءٍ} وقد عرف الصحيح من الوجهين.وقوله: {ما قُتِلْنا هاهنا} جواب {لَوْ} وجاء على الأفصح، فإن جوابها إذا كان منفيًا بـ {ما} فالأكثر عدم اللام، وفي الإيجاب بالعكس، وقد أعرب الزمخشريُّ هذه الجُمَلَ الواقعة بعد قوله: {وطائفة} إعرابًا أفْضى إلى خروج المبتدأ بلا خبر فقال: فإن قُلتَ: كيف مواقعُ هذه الجُمَلِ الواقعة بعد قوله: {وطائفة}.قُلْتُ: {قَدْ أَهَمَّتْهُمْ} صفة لـ {طَائِفَةٌ} و{يَظُنُّونَ} صفة أخرى، أو حالٌ، بمعنى: قد أهمتهم أنفسهم ظَانِّين، أو استئنافٌ على وجه البيانِ للجملة قبلها و{يَقُولُونَ} بدلٌ من {يَظُنُّونَ}. اهـ. بتصرف.
|